
غالباً ما تكون مهن الكتاب ذات انعكاسات سلبية على كتاباتهم، وبخاصة في بلداننا العربية، حيث التفرغ نادر، واعتماد الكاتب على مبيعات كتبه شبه معدوم؛ مما يضطره إلى العمل في مهن أخرى، قد تتناقض تماماً مع شخصيته واهتماماته الأساسية، فتستنزف طاقته، وتستهلك كثيراً من وقته، المفروض أن يكرّس لنتاجه وإبداعه. من ناحية أخرى. لكن هناك من يرى أن مهنته قد انعكست إيجابياً على كتاباته، وشكلت مصدراً مهماً في رفد تجربته على شتى المستويات:
هنا آراء كتّاب وروائيين وتشكيليين مصريين حول معادلة العمل والإبداع:
- الكاتبة سلوى بكر: وزارة التموين... والصحافة
تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1972، وتم تعيني في وزارة التموين مفتشةً، في تلك السنوات كانت الدولة هي التي تقوم بتعيين الخريجين الجدد. وأتاحت لي هذه المهنة فرصة عظيمة للتعرف على القاع الاجتماعي والحياة المجردة للشارع المصري كما هي موجودة بالفعل. عملت نحو 6 سنوات التقيت فيها نماذج إنسانية متباينة، وتعرفت على آليات القهر الاجتماعي المقننة، التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها من الأمور الطبيعية أو من قبيل البديهيات. وعشت لحظات تاريخية في أثناء عملي هذا، فرأيت على سبيل المثال بأم عيني كيف بدأت ثورة الجوع في مصر (مظاهرات الخبز) عام 1977.
كانت أوقاتاً عصيبة؛ لأن الثورة بدأت بالفعل عندما توجه الفقراء إلى مكاتب التموين الحكومية للتساؤل عن أسباب رفع الأسعار المفاجئ للسلع الغذائية الأساسية، وما يطلق عليها السلع الاستراتيجية، مثل الخبز والأرز وما شابه. هذه الفترة من عملي كانت مؤثرة في إنتاجي الأدبي فكتبت قصة بعنوان «أم شحته»، وكذلك قصة «امرأة على العشب»، كما أن الكثير من خيوط عوالم روايتي «العربة الذهبية لا تصعد للسماء» مستمدة مما لمسته وعشته عن قرب في تلك الأثناء. على مستوى آخر من المهن، عملت صحافيةً في صحيفة لبنانية، فانتقلت على أثرها إلى بيروت. وأتاح لي هذا العمل، الذي كان خلال فترة احتدام الصراع العربي – الإسرائيلي، والعدوان الصهيوني على أشده في لبنان، إنتاج مجموعة من القصص والكتابات عن نماذج إنسانية ولحظات فارقة تتعلق بهذا الزمن الذي لم أعش مثله من قبل كقصة «ابن خمسين يوم» و«عباس أجوسك». إن المناخات التي يحيا على متنها المبدع مؤثرة في تركيبته الإبداعية، وتعد بمثابة مصادر خام حية ترفد تجربته على شتى المستويات؛ فقد تأثر مناخ كتابتي بعوالم المهن التي اشتغلت بها، وربما أيضاً يتضح ذلك في رواية «ليل ونهار»، وهي رواية عن علاقة بين صحافية شابة ورجل ثري، وكنت متأثرة في ذلك بأجواء العمل الصحافي الذي عشته في بيروت وقبرص وتونس.
تأثير هذه التجارب لم يقتصر على المستوى النفسي أو الإدراكي، بل على المستويات التقنية والأدوات كاللغة، فعندما تخالط جماعات إنسانية في مستويات اجتماعية وثقافية متباينة، فهذا دون شك سيؤثر على المنظومة اللغوية داخلك، فربما عملي مفتشة تموين ومخالطتي الطبقات الشعبية كان وراء حرصي على استنطاق كل شخصية من شخصيات أعمالي القصصية أو الروائية بلغتها، وتفعيل قاموسها اللغوي الخاص بها، وتعلمت أيضاً من خلال المعايشة أن أنتبه إلى بلاغة الذين يبدون للوهلة الأولى وكأن لغتهم تفتقر إلى البلاغة، حيث اكتشفت أن الناس تتحدث بما أسميه بـ«فصيح العامية».
- الفنان عادل السيوي: الطب والرسم
بدأت علاقتي بالمهنة منذ تخرجي في كلية الطب جامعة القاهرة سنة 1970، لكنني لم أجرب أبداً الإحساس المكتمل بكوني طبيباً. في بداية الدراسة كنت متفوقاً، وعندما بدأت الشكوك تساورني حول علاقتي بهذه المهنة انعكس ذلك على تحصيلي وحماسي، لكنني تخرجت رغم ذلك بتقدير جيد جداً.
الطب مهنة ساحرة بالفعل ومدهشة بقدر غموض وغرابة حضورنا الجسدي الحي داخل هذا الكون المصمت، حيث إن اكتشاف الجسد بوصفة آلة بيولوجية، ثم التعرف على الوظائف، ثم مناطق الخلل وطرق تشخيصها وصولاً إلى الحلول الممكنة. إنها رحلة بديعة من التأمل والذكاء، والخبرة، والحدس، ومن التعاطف والتضامن أيضاً بين الأحياء إلى جانب الكثير من الأرقام والتحاليل وخلافه. ثم، درست وأنا طالب طب بالقسم الحر في بكلية الفنون الجميلة عامين متواليين، وكان لذلك دلالة على أن علاقتي بالرسم قد تجاوزت حدود الولع. لكن الفترة التي يمكن أن أقول إنها قد تركت بصمة كبيرة على روحي من جراء المهنة هي السنة وبضعة الأشهر التي قضيتها بمستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية طبيباً نفسياً، والتي قررت بعدها السفر إلى إيطاليا وقطع علاقتي بالطب تماماً، حيث أدركت في تلك الفترة القصيرة مدى هشاشة العقل وقابلية الروح للانشطار، بل التفتت، وفهمت قوة الجنون وقدرته الفذة على خلق منطق صلب لا يقبل القسمة على اثنين. وما بين ترك الطب واحتراف الفن عبرت بفترة انتقالية طويلة عملت خلالها مترجماً، وهي المهنة التي أدخلتني إلى علاقة مغايرة باللغة، والنصوص، وقادتني بعد ذلك للانتقال إلى الترجمة اختياراً حراً، لا يكلفني بها أحد، أترجم نصوصاً أحبها كنظرية التصوير لليوناردو دافنشي، أو الأشعار الكاملة للشاعر الإيطالي أونجاريتي. مهنة الترجمة لها أفضال كبيرة عليّ؛ فقد مكنتني من تجاوز تلك المرحلة الانتقالية دون معاناة كبيرة، وبخاصة أني كنت مقيماً في ميلانو، وهي مدينة تتطلب الإقامة فيها تكاليف باهظة، كنت أحلم بأن أقضي حياتي رساماً، وأن أضع أشكالاً وخطوطاً وألواناً فوق الأسطح، وأن تكون هذه المهمة هي حياتي وطريقة وجودي في العالم، الرسم ليس مهنتي رغم احترامي لاستحقاقات الاحتراف كاملة، لكن الرسم كان طريقتي في الوجود.
- الشاعر فؤاد حجاج: الغزل والنسيج... والشعر
لا بد من التفريق بين المهنة أو الصنعة التي تكفل لصاحبها لقمة العيش والحياة الكريمة، والإبداع الذي لا حدود له ولا جدران. فقد عملت في بداية رحلتي مراقباً للإنتاج بإحدى شركات الغزل والنسيج قبل بيع القطاع العام. ولأنني ممسوس بالإبداع الأدبي كنت مسؤولاً ثقافياً بمنظمة الشباب فاقترحت عمل مجلة حائط في مدخل الشركة ليراها العمال في دخول وخروج الورديات، ولتكون بداية لخلق حالة من الرغبة في القراءة والاضطلاع، ونجحت في جذب الاهتمام والمتابعة، واكتشفت الكثير من المواهب بين العمال، كما قمت بإيجاد نشاط ثقافي ملموس بنادي الشركة. وكانت محطة أخرى في رحلتي، حيث توليت منصبي الجديد أميناً لمكتبة النادي، وكانت فرصتي الذهبية لكي أقرأ يومياً لمدة 8 ساعات كاملة. قرأت الأعمال الكاملة لعشرات الكتاب في مصر والعالم، وكنت مولعاً بويليام شكسبير، وقرأت الـ36 مسرحية بواقع مسرحية كل يوم، كما قرأت أعمال نجيب محفوظ كاملة منذ البداية الفرعونية الباكرة. انتقلت بعد ذلك لمسؤولية ثقافية أكثر اتساعاً، حيث أصبحت المسؤول الثقافي لقطاع شبرا الخيمة باتساعها، فأتيحت لي فرصة العمل المباشر مع 11 مركز شباب لأكتشف الكثير من المواهب، وتزامن هذا مع دراستي الإعلام في الدفعة الأولى بالجامعة العمالية لكي أتولى صفحة الأدب فيما بعد في جريدة «العمال» الأسبوعية.
كل تلك المحطات تركت أثراً في شعري، وعمّقت إحساسي بالمسؤولية تجاه قضايا وطني؛ ما انعكس جلياً في الكتابة للإذاعة والتلفزيون، وفي الكثير من البرامج الشعرية التي أعتز بها، وقمت بإعدادها وكتابة مادتها مثل «أوراق من شجرة أكتوبر»، الذي أذيع على القناة الأولي بالتلفزيون المصري في أواخر الثمانينات في 30 حلقة بشكل يومي بصوتي وصوت سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب.
- الروائي حمدي البطران: البوليس... والكتابة
إن المهنة الأولى أو المهن تعد ركناً أساسياً في الوعي الفكري لأي كاتب، ففيها تنحصر تجاربه الأولى مع المجتمع والناس، وتنعكس سلباً أو إيجاباً على أدبه وكتاباته. من خلال المهنة يرى الكاتب المجتمع الذي يتعامل معه، وتتبلور فكرته وأفكاره وتجاربه من خلال تلك الوظيفة؛ فهو يرى العالم حوله بعيون وظيفته.
كانت مهنتي الأولى ضابطاً في البوليس، وأتاح لي هذا أن أتعمق في المجتمع من خلال طبقاته ومآسيه، كما أتاح لي موقعي أن أرى الوطن في حالاته المختلفة؛ فالشرطة هي انعكاس كامل لحالة المجتمع، فكانت كتاباتي تعالج هذا الجانب المتروك من المجتمع الذي لم يتحدث عنه أحد.
كتبت على أثر ذلك رواية «يوميات ضابط في الأرياف» و«كل شيء هادئ في الجنوب» و«خريف الجنرال»، وهي أعمال تبحث وتفتش في هذا العالم الغريب.
لكن هناك تجاهلاً تاماً لما أكتبه أنا وأمثالي لاعتبارات كثيرة، منها أن هناك من يغار من مهنتنا السابقة ويراها سبباً لكراهيتنا، وعدم التعامل مع ما نكتبه بالجدية المطلوبة، وهناك من يرى أننا نحاول أن نكون أدباء من أجل نوع من الوجاهة، لكن الأمر لم يكن إلا رغبة عارمة في أن نقول كلمة صادقة للناس، من واقع ما عشناها ولمسناه عن قرب، عبر هذه المهن السابقة.


- المقالات
- حوارات
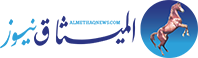





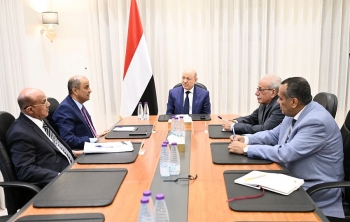









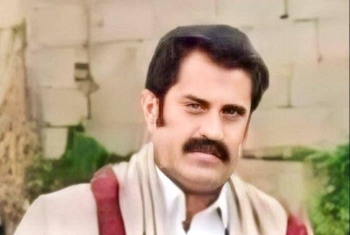




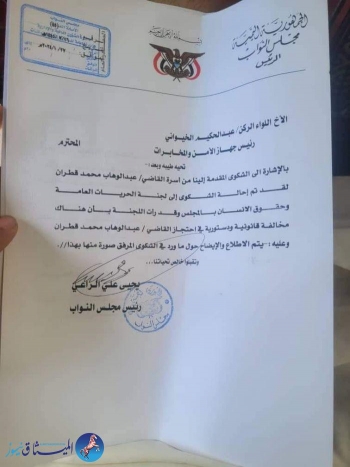
 بالزي الفرعوني.. أحلام تتألق في حفل افتتاح المتحف الكبير
بالزي الفرعوني.. أحلام تتألق في حفل افتتاح المتحف الكبير موعد حفل هاني شاكر في الكويت
موعد حفل هاني شاكر في الكويت الشاعرُ اليمنيُّ علي أحمد قُلي يُحيي أمسيةً شعريةً في الرياض برعايةِ نادي سموّ الحرف
الشاعرُ اليمنيُّ علي أحمد قُلي يُحيي أمسيةً شعريةً في الرياض برعايةِ نادي سموّ الحرف تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية للفنان المغربي مصطفى سوليت
تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية للفنان المغربي مصطفى سوليت القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بالاعتداء على نجل رجل أعمال
القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بالاعتداء على نجل رجل أعمال وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما
وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما











