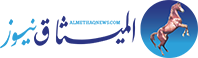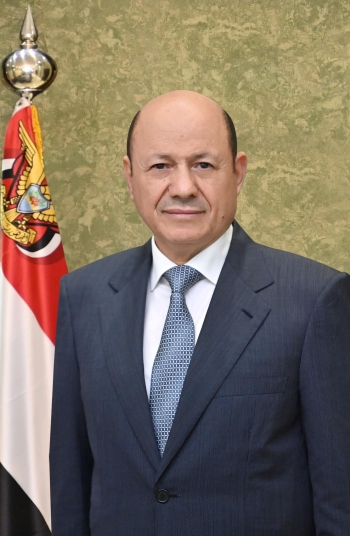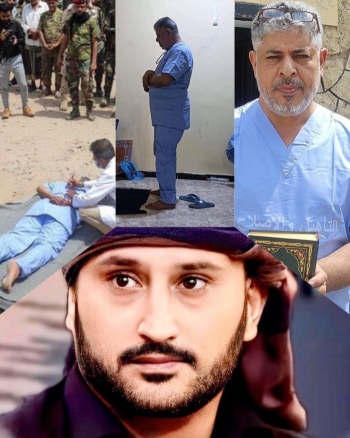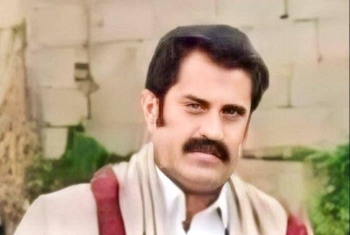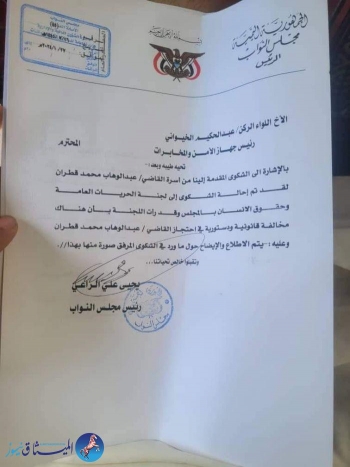نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرًا أعدّه المدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية “روبرت مالي”، كشف فيه عن نزاعات وتطورات سيئة يجب الحذر منها خلال العام 2020، قال فيه:
لم يعد الأصدقاء والأعداء يحفظون للولايات المتحدة مكانتها المعهودة. ومع ما أصاب واشنطن من الضعف وتراجع في الأداء، تسعى القوى الإقليمية إلى إيجاد حلول منفردة، وذلك من خلال العنف والدبلوماسية.
تُعدّ النزاعات المحلية مرايا للاتجاهات العالمية؛ فطُرق اندلاعها وخوضها وحلها تكشف تحولات كبيرة في علاقات القوى العظمى، وشدة المنافسة بينها، واتساع طموحات الجهات الفاعلة الإقليمية، كما أنها تسلّط الضوء على القضايا التي يهتم بها النظام الدولي وتلك التي لا يهتم بها. وتروي هذه الحروب اليوم قصة نظام عالمي اشتعلت فيه الطفرة المبكرة من التغيير الشامل، فيما يشعر الزعماء الإقليميون بالجرأة والخوف من الفرص التي يتيحها مثل هذا الانتقال.
كما تتغير أدوار القوى الكبرى في العالم أيضًا. فها هي الصين تسير في أناة وثقة في تأثيرها، ولكنها ليست في عجلة من أمرها لبسط نفوذها بشكل كامل. فهي تختار معاركها، مع التركيز على الأولويات المحددة ذاتيًّا: حيث ستسعى خلال العام الجديد إلى السيطرة في الداخل وستعمل على قمع المعارضة كما حصل في هونغ كونغ، إضافةً إلى الاعتقال الجماعي للمسلمين في شينجيانج. وستشتدّ الحرب التكنولوجية بينها وبين الولايات المتحدة.
وعلى النقيض من ذلك، تبدو روسيا نافدة الصبر وتتوق إلى تأكيد قوتها وإثباتها قبل فوات الأوان. وسياسة موسكو في الخارج انتهازية، حيث تسعى إلى تحويل الأزمات الخارجية إلى مصلحتها، وهي تدعم حلفاءها عسكريًّا مباشرة مع إرسال مقاولين من القطاع الخاص إلى ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أجل تعزيز نفوذها المتزايد.
بالنسبة لجميع هذه القوى، فإن منع نشوب الصراعات أو حلها ينطوي على قيمة متأصلة ضئيلة. فهي تقيم الأزمات من حيث كيفية تقدمهم أو الإضرار بمصالحهم، وكيف يمكنهم تعزيز أو تقويض مصالح خصومهم، ويمكن أن تمثّل أوروبا رمانة ميزان، لكن في اللحظة التي تحتاج فيها بالتحديد إلى الاختراق، فإنها تكافح الاضطرابات الداخلية، والشقاق بين قادتها، والانشغال المفرط بالإرهاب والهجرة التي غالبًا ما تشوّه السياسة.
عواقب هذه الاتجاهات الجيوسياسية يمكن أن تكون قاتلة، ويمكن للإيمان المبالغ فيه بالمساعدة الخارجية أن يشوه حسابات الجهات الفاعلة المحلية، ويدفعها نحو مواقف لا هوادة فيها ويشجعها على التغلب على الأخطار التي تعتقد أنها محصنة ضدها.
فالأزمة في ليبيا تواجه خطر حدوث تطور خبيث وخطير، وبينما تتدخل روسيا نيابةً عن قائد عام يسير في العاصمة، تُرسل الولايات المتحدة رسائل مشوشة، فيما تهدّد تركيا بالتدخل لإنقاذ الحكومة، وتُظهِر أوروبا – التي هي على مرمى حجر من ليبيا – عجزًا وسط خضم هذه الخلافات.
أما الوضع في فنزويلا، فيتمثل في تعنت الحكومة، التي يدعمها الإيمان بأن روسيا والصين ستحدان من تدهورها الاقتصادي، وهي تتعارض مع افتقار المعارضة إلى الواقعية، بدعم من الاقتراحات الأمريكية بأنها ستطرد الرئيس “نيكولاس مادورو”.
ولم يكن هذا الصراع مدرجًا في تلك القائمة، حيث كانت سوريا نموذجًا مصغرًا لكل هذه الاتجاهات: فهناك قامت الولايات المتحدة بدمج قنابل الهيمنة مع المتفرجين من المارة، وجرى تشجيع الجهات الفاعلة المحلية (مثل الأكراد) بسبب المبالغة في تقدير الولايات المتحدة، ومن ثم خيبة أملها من تراجع الدعم الأمريكي. وفي الوقت نفسه، وقفت روسيا بحزم وراء حليفها الوحشي، في حين سعى آخرون من دول الجوار (أي تركيا) للاستفادة من تلك الفوضى.
وبالنسبة للعديد من الأمريكيين، تثير أوكرانيا قصة رهيبة عن سياسة المقايضة والعزل. لكن بالنسبة لرئيسها الجديد الذي جاء في قلب تلك العاصفة، “فولوديمير زيلينسكي”، تتمثل الأولوية في إنهاء الصراع في شرق البلاد، وهو يدرك من خلال ذلك حاجة كييف إلى تسوية.
وهناك اتجاه آخر يسترعي الانتباه: ظاهرة الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم. إنه استياء من تكافؤ الفرص، ويزعزع الدول التي يحكمها كل من اليسار واليمين، والديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، الغنية والفقيرة، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا وأفريقيا، غير أن اللافت للنظر بشكل خاص هم أولئك الموجودون في الشرق الأوسط؛ لأن العديد من المراقبين اعتقدوا أن الأوهام المكسورة وإراقة الدماء المروعة التي جاءت في أعقاب ثورات 2011 من شأنها أن تُثني الجميع عن جولة أخرى.
لقد تعلم المتظاهرون الدروس واستقروا في المدى الطويل، وتجنبوا في معظم الأحيان العنف الذي يمارسه المتنافسون، كما تعلمت النخب السياسية والعسكرية، بالطبع، اللجوء إلى وسائل مختلفة للتغلب على العاصفة. ففي السودان، التي يمكن القول إنها إحدى القصص الإخبارية الأفضل للعام الماضي، أدت الاحتجاجات إلى سقوط البشير، وشهدت مرحلة انتقالية يمكن أن تتمخض عن نظام أكثر ديمقراطية وسلمية. وفي الجزائر، لعب القادة لعبة الكراسي الموسيقية، وفي العديد من الأماكن الأخرى، قاموا بقمع تلك الاحتجاجات، ومع ذلك، لا يزال الإحساس السائد بالظلم الاقتصادي الذي أخرج الناس إلى الشوارع قائمًا. ومن هنا فإنه إذا لم تستطع الحكومات الجديدة أو القديمة معالجة ذلك، فعلى العالم أن يتوقع اشتعال المزيد من المدن العام القادم.
1- أفغانستان
سقط عدد كبير من الضحايا جراء الصراع في أفغانستان أكثر من أي صراع حالي آخر في العالم. ومع ذلك، قد تكون هناك بارقة أمل هذا العام لبدء عملية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.
وقد ارتفعت مستويات سفك الدماء خلال العامين الماضيين، وفُجعت العديد من المدن الأفغانية بهجمات منفصلة قام بها مقاتلو طالبان وداعش، بينما شهد الريف عمليات أقل. وفي المقابل صعَّدت واشنطن وكابول من هجماتهما وغاراتهما الجوية التي تشنها القوات الخاصة، وغالبًا ما يتحمل المدنيون وطأة هذا العنف.
وفي العام الماضي، كان هناك بعض الضوء في دبلوماسية الولايات المتحدة وطالبان؛ فلأول مرة منذ بدء الحرب، أعطت واشنطن الأولوية للتوصل إلى اتفاق مع الحركة.
وبعد شهور من المحادثات الهادئة، وافق المبعوث الأمريكي “زلماي خليل زاد” وقادة طالبان على مسودة اتفاق ممهورة بالأحرف الأولى. وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان – وهو مطلب طالبان الأساسي– وفي المقابل، وعدت طالبان بالخروج من تنظيم القاعدة، ومنع القاعدة من استخدام أفغانستان للتخطيط لشن هجمات في الخارج، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية وكذلك سماسرة السلطة الآخرين.
لكن هذه الآمال تلاشت عندما أعلن ترامب فجأة إنهاء المحادثات في أوائل سبتمبر. وكان قد دعا قادة طالبان إلى كامب ديفيد، إلى جانب أشرف غني، وعندما رفضت حركة طالبان الذهاب إلى كامب ديفيد ما لم يتم التوقيع على الاتفاق أولاً، تذرَّع ترامب بهجوم طالبان الذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي لإلغاء الاتفاق الذي وقع عليه مبعوثه.
ولذلك يجب أن يمهّد أي اتفاق الطريق للمحادثات بين الأفغان، وهو ما يعني ربط وتيرة انسحاب القوات الأمريكية بكل من أهداف مكافحة الإرهاب ومشاركة طالبان بنية حسنة في المحادثات مع الحكومة الأفغانية وغيرها من القادة الأفغان الأقوياء. إن اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان سيمثل بداية طريق طويل للتوصل إلى تسوية بين الأفغان، وهو شرط أساسي للسلام، ومن المؤكد أنه يوفر الأمل الوحيد لتهدئة الحرب الأكثر دموية اليوم.
2- اليمن
في عام 2018، منع التدخل الدولي في اليمن ما اعتبره مسئولو الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ وقد يوفر عام 2020 فرصة نادرة لإنهاء الحرب. وهي فرصة مواتية نتيجة التقاء العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم اغتنامها الآن؛ فسرعان ما ستتلاشى.
لقد كانت التكلفة البشرية للحرب واضحة بشكل شديد الإيلام، فقد قُتل بشكل مباشر ما يقدّر بنحو 100 ألف شخص، بينما باتت أحد أفقر دول العالم العربي على شفا مجاعة، وأصبح اليمن خط الصدع الحاسم في التنافس على مستوى الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى. وبعد عام من احتلالها العناوين الرئيسية الدولية لفترة وجيزة، بات الصراع المستمر منذ خمس سنوات معرضًا لخطر النسيان في الوعي الدولي.
وقد شجع اتفاق ديسمبر 2018 المعروف باسم اتفاقية ستوكهولم على وقف هش لإطلاق النار حول مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا والمتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء منه في سبتمبر 2014. وقد حال هذا الاتفاق دون حدوث مجاعة وتم إيقاف القتال بفاعلية بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، كانت الجوانب الأكثر ديناميكية للنزاع هي معركة داخل الجبهة المناهضة للحوثيين التي حرضت الانفصاليين الجنوبيين ضد حكومة هادي، وحرب عبر الحدود شهدت إطلاق الحوثيين للصواريخ على الحدود ردًّا على الغارات الجوية السعودية. وتنعكس نافذة الأمل اليوم على هاتين الجبهتين الأخيرتين:
أولاً، دفع القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في أغسطس 2019 الكتلة المعادية للحوثيين إلى درجة الانهيار. وردًّا على ذلك، لم يكن لدى الرياض من خيار سوى التوسط في هدنة بينهما للحفاظ على مجهودها الحربي.
ثانيًا: في شهر سبتمبر، أبرز هجوم صاروخي على منشآت نفطية سعودية مهمة – تبناها الحوثيون، ولكن يشتبه أن طهران هي التي نفذته – مخاطر الحرب التي يمكن أن تنخرط فيها الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج ضد إيران، والتي لا يرغب فيها أحد.
وقد ساعد ذلك في دفع السعوديين والحوثيين للانخراط في محادثات تهدف إلى تخفيف حدة النزاع وإخراج اليمن من ساحة الصراع الإقليمي السعودي الإيراني على النفوذ؛ وخفّض الجانبان بشكل كبير من الضربات عبر الحدود. وإذا أدت هذه المحادثات إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة عام 2020، فقد تلوح نهاية الصراع في الأفق.
غير أن الفرصة ربما تتبخر. فانهيار الصفقة الهشة للحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب – أو اتفاقها الهش مع الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر– من شأنه أن يعرقل جهود صنع السلام. إن نفاد صبر الحوثيين إزاء ما يعدّونه تباطؤًا من السعوديين في الانتقال من وقف التصعيد إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب حصولهم على كمية كبيرة من الصواريخ، يمكن أن يُشعلَ الحرب عبر الحدود بسرعة. ويمكن أن تتصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية أيضًا وتصل إلى اليمن. بعبارة أخرى، لا ينبغي الخلط بين هدوء الصراع العنيف في النصف الثاني من عام 2019 وطبيعته الجديدة؛ ينبغي اغتنام فرصة السلام الآن.
3- إثيوبيا
ربما تكون إثيوبيا هي المكان الأكثر خطورة بالنسبة للسنة المقبلة، فهي الدولة الأكثر تأثيرًا واكتظاظًا بالسكان في شرق إفريقيا.
ومنذ توليه منصبه في أبريل 2018، اتخذ رئيس الوزراء “آبي أحمد” خطوات جريئة لفتح سياسة البلاد. لقد أنهى مواجهة دامت عقودًا مع إريتريا، وأفرج عن السجناء السياسيين، ورحّب بالمتمردين العائدين من المنفى، وعيّن إصلاحيين في المؤسسات الرئيسية، وقد فاز بالجوائز في الداخل والخارج، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام لعام 2019.
لكن التحديات الهائلة تلوح في الأفق. كانت الاحتجاجات الجماهيرية بين عامي 2015 و2018 التي أوصلت آبي إلى السلطة مدفوعة في المقام الأول بالمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، غير أنها كان لها دلالات عرقية أيضًا، لا سيما في أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظًا بالسكان، أمهرة وأوروميا، حيث كان قادة تلك المناطق يأملون في الحد من نفوذ أقلية تيجراي المهيمنة منذ فترة طويلة. لقد أعطى تحرر آبي وجهود تفكيك النظام الحالي طاقة جديدة للإثنية، مع إضعاف الدولة المركزية.
وتصاعد الصراع العرقي في جميع أنحاء البلاد؛ ما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الملايين وإذكاء العداوة بين قادة أقوى مناطقها. وقد تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو 2020 عنيفة ومثيرة للخلاف، حيث يتفوق المرشحون على بعضهم البعض في الدعوات العرقية لجذب الأصوات.
ومما يزيد من حدة التوتر، الجدال المرير حول النظام الفيدرالي الإثني في البلاد، والذي يؤول سلطته إلى مناطق محددة على أساس الخطوط الإثنية اللغوية؛ حيث يعتقد أنصار النظام أنه يحمي حقوق المجموعة في بلد متنوع يتكون من الغزو والذوبان. بينما يقول المنتقدون إن النظام القائم على أساس عرقي يضر بالوحدة الوطنية، ويقولون إن الوقت قد مضى لتجاوز السياسة العرقية التي ألجمت الأمة وقسمتها منذ وقت طويل.
لقد سعى آبي إلى حل وسط، غير أن بعض الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك اندماجه وتوسيعه للائتلاف الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، نقلته إلى معسكر الإصلاحيين. وخلال العام المقبل، سيتعين عليه بناء جسور بين المناطق الإثيوبية، حتى أنه ينافس مع الإثنيين في صندوق الاقتراع. وسيتعين عليه التغلب على الجدل الدائر من أجل التغيير مع استرضاء حارس قديم ربما قد يخسره.
ولا يزال انتقال إثيوبيا مصدرًا للأمل ويستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، ولكن هذا الانتقال يواجه خطر الانهيار بعنف. ففي أسوأ الحالات، يحذر البعض من أن البلاد قد تنكسر كما حدث في يوغوسلافيا في التسعينيات؛ ما ينذر بعواقب وخيمة على منطقة هي مضطربة بالفعل. ويتعين على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يقدموا ما في وسعهم– بما في ذلك الضغط على جميع قادة البلاد للحد من الخطاب العرقي العدائي، وتقديم المشورة لرئيس الوزراء لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، وتقديم مساعدات مالية متعددة السنوات– لمساعدة آبي في تجنب مثل هذه النتيجة.
4- بوركينا فاسو
بوركينا فاسو هي أحدث دولة تقع ضحية لعدم الاستقرار الذي تعاني منه منطقة الساحل في إفريقيا، فالمتشددون الإسلاميون يشنون تمردًا في شمال البلاد منذ عام 2016. وقد قاد التمرد في البداية جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة يقودها “إبراهيم مالام ديكو”، وهو واعظ محلي بوركيني. وعلى الرغم من أنه يستقر في شمال بوركينا فاسو، إلا أنه يبدو أن له علاقات وثيقة بالجهاديين في مالي المجاورة. وبعد وفاة ديكو في اشتباكات مع القوات البوركينية عام 2017، تولى شقيقه “جعفر” القيادة، ولكن يقال إنه قُتل في غارة جوية في أكتوبر 2019.
وقد أدى انتشار العنف إلى تشريد حوالي نصف مليون شخص (من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 20 مليون نسمة) ويكون تحديد المسئول عن هذا العنف أكثر غموضًا. فبالإضافة إلى جماعة أنصار الإسلام، هناك الجماعات الجهادية المتمركزة في مالي، بما في ذلك تنظيم داعش والجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، التي تنشط الآن في بوركينا فاسو.
لا يقف الضرّر الذي يسببه الاضطراب في بوركينا فاسو على مواطنيها فحسب، بل يمتد إلى دول الجوار حولها، حيث عانت تلك الدول من هجمات الجهاديين منذ عام 2016. لكن بعض الأدلة، بما في ذلك بيانات المسلحين الخاصة، تشير إلى أنهم قد يستخدمون بوركينا فاسو كنقطة انطلاق لعمليات على طول الساحل أو لإنشاء قاعدة لهم في المناطق الشمالية القصوى من دول مثل ساحل العاج أو غانا أو بنين.
إن تركز التعاون بين بوركينا فاسو وجيرانها حتى الآن على العمليات العسكرية المشتركة. وقد تستعد الدول الساحلية للقيام بنفس الشيء. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تركز الحكومات في المنطقة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود، والسياسات الرامية إلى كسب القرويين في المناطق المتأثرة، ودون هذه الإجراءات، فإن الاضطرابات ستستمر أكثر وأكثر.
5- ليبيا
تنذر الحرب في ليبيا بأن تكون أسوأ في الأشهر المقبلة، حيث تعتمد الفصائل المتناحرة بشكل متزايد على الدعم العسكري الأجنبي لتغيير ميزان القوى. وتزايدت أعمال العنف الكبرى منذ تقسيم البلاد إلى إدارتين متوازيتين في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في عام 2014. فيما تعثرت محاولات الأمم المتحدة لإعادة توحيد البلاد، ومنذ عام 2016 انقسمت ليبيا بين حكومة رئيس الوزراء “فايز السراج” المعترف بها دوليًّا في طرابلس وحكومة منافسة مقرها في شرق ليبيا. وفي ظل هذا التناحر؛ عزّز تنظيم داعش لنفسه موطئ قدم صغير لكنه هُزم، وتحاربت الميليشيات على البنية التحتية النفطية الليبية على الساحل؛ بينما زعزعت الاشتباكات القبلية الاستقرار في الصحراء الجنوبية الشاسعة للبلاد؛ غير أن القتال لم يتصاعد إلى مواجهة أوسع.
لكن الوضع خلال العام الماضي أخذ منعطفًا خطيرًا جديدًا. ففي أبريل 2019، فرضت قوات خليفة حفتر، المدعومة من الحكومة في الشرق، حصارًا على طرابلس؛ ما دفع البلاد نحو حرب شاملة. ويزعم حفتر أنه يحارب الإرهابيين، وفي حين أن بعض منافسيه من الإسلاميين، إلا أنهم كانوا نفس الميليشيات التي دحرت تنظيم داعش – بدعم من الولايات المتحدة والغرب – منذ ثلاث سنوات.
ولطالما كانت ليبيا ساحة للمنافسة الخارجية. ففي خضم الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم السابق “معمر القذافي” عام 2011، طلبت الفصائل المتنافسة الدعم من الرعاة الأجانب. وقد أججت الخصومات الإقليمية الانقسام بين الحكومتين المتنافستين والائتلافين العسكريين لكل منهما، حيث دعمت كل من مصر والإمارات قوات حفتر، فيما دعمت تركيا وقطر الجماعات الغربية المسلحة الموالية لسراج.
ولم يجد هجوم حفتر الأخير دعمًا في القاهرة وأبو ظبي فحسب؛ بل وأيضًا في موسكو، التي قدمت مساعدات عسكرية لحفتر تحت غطاء شركة أمنية خاصة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت إدارته حكومة السراج وعملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة منذ توليه منصبه، فقد غيّر مساره في أبريل 2019، بعد اجتماع مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”. وفي المقابل زادت تركيا بدورها من دعمها لطرابلس، حيث ساعدت حتى الآن في تجنب سقوطها في أيدي قوات حفتر، والآن تهدد أنقرة بمزيد من التدخل.
إن انتشار الجهات الفاعلة يعيق الجهود الرامية إلى إنهاء سفك الدماء وإحلال السلام. ويبدو أن المحاولة التي قادتها الأمم المتحدة في برلين لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات ذهبت أدراج الرياح. وسواء سيُعقد مؤتمر السلام الذي تأمل الأمم المتحدة وألمانيا عقده في أوائل عام 2020 أم لا. فمن جانبهم، وقف الأوروبيون عاجزين. وكان شاغلهم الشاغل هو التحقق من تدفق المهاجرين، لكن الخلافات بين الزعماء حول كيفية الموازنة سمحت للاعبين الآخرين بتأجيج الصراع الذي يقلل بشكل مباشر من مصلحة أوروبا في ليبيا مستقرة.
ولإنهاء الحرب، يتعين على القوى الأجنبية التوقف عن تسليح حلفائها الليبيين والضغط عليهم في المفاوضات بدلاً من ذلك، لكن احتمالات حدوث ذلك تبدو بعيدة. ولذا فإن النتيجة قد تكون مأزقًا أكثر تدميرًا، كما أن الاستيلاء على طرابلس يمكن أن يؤدي إلى قتال طويل الأمد بين ميليشيات متناحرة، بدلاً من حكومة واحدة مستقرة.
6- الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والخليج العربي
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل خطير في عام 2019؛ ويمكن أن يصل التنافس في العام المقبل إلى نقطة الغليان. فقرار إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات أحادية متصاعدة ضد طهران لم يتسبب في تكاليف باهظة، ولكنه لم ينتج عنه حتى الآن الاستسلام الدبلوماسي الذي تسعى إليه واشنطن، ولا الانهيار الداخلي الذي قد تأمل في تحقيقه. وبدلًا من ذلك، استجابت إيران لما اعتبرته حصارًا شاملاً من خلال زيادة تدريجية في برنامجها النووي في انتهاك للاتفاقية، واستعراض عضلاتها الإقليمية بقوة، وقمع أي بادرة لحدوث اضطرابات داخلية بحزم. فيما تصاعد التوتر أيضًا بين إسرائيل وإيران، وما لم يتم التغلب على هذه الدوامة، فإن خطر حدوث مواجهة أوسع سوف يزداد.
كان تحول طهران من سياسة أقصى درجات الصبر إلى سياسة الحد الأقصى للمقاومة نتيجة انتهاز الولايات المتحدة لإحدى الفرص المتاحة أمامها: إنهاء الإعفاءات المحدودة بالفعل على مبيعات النفط الإيرانية. وفي ظل تحقيق القليل من الارتياح من الأطراف المتبقية في الصفقة النووية، أعلن الرئيس “حسن روحاني” في مايو الماضي أن حكومته ستبدأ في خرق الاتفاقية تدريجيًّا. ومنذ ذلك الحين، تخطت إيران الحدود القصوى لمعدلات تخصيب اليورانيوم وأحجام مخزوناتها، وبدأت في اختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، واستأنفت نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.
ومع تزايد الخروقات، قد تفشل إيران في تحقيق مكاسب في مجال حظر الانتشار النووي إلى الحد الذي يقرر فيه الموقعون الأوروبيون أنه يتعين عليهم فرض عقوباتهم الخاصة عليها. وفي مرحلة ما، قد يدفع التقدم الإيراني إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى العمل العسكري.
وقد دفع الاعتراف بالمخاطر البالغة وتكاليف الحرب بعض المنافسين الإيرانيين في الخليج العربي إلى السعي إلى وقف التصعيد، حتى مع استمرارهم في دعم نهج “أقصى ضغط” لإدارة ترامب. فمن جهتها فتحت الإمارات العربية المتحدة خطوط اتصال مع طهران، فيما دخلت المملكة العربية السعودية في حوار جاد مع الحوثيين في اليمن.
ودفعت احتمالية الصراع أيضًا إلى بذل جهود بقيادة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لمساعدة الولايات المتحدة وإيران في إيجاد حل دبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي يتوق إلى تجنب الحرب، على استعداد لسماع اقتراحه، كما كان الإيرانيون مهتمين أيضًا بأي اقتراح يرفع بعض العقوبات.
لكن مع انعدام الثقة العميق بين الأطراف، ينتظر كل منهما الآخر لتقديم التنازلات أولًا. ولا يزال من الممكن تحقيق انفراج على الصعيد الدبلوماسي لتهدئة التوترات بين دول الخليج وإيران أو بين واشنطن وطهران، ولكن مع فرض مزيد من العقوبات على العراق وإيران، فإن الوقت يداهم الجميع.
7- الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
في عام 2017، وبعد أن تبادل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وزعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” الإهانات والتهديدات بالإبادة النووية؛ بدا في عام 2019 ذلك وكأنه حدث منذ زمنٍ بعيد، غير أن التوترات تصاعدت.
وأدت مخاطر عام 2017 إلى هدوء نسبي عام 2018 وأوائل عام 2019. وأوقفت الولايات المتحدة معظم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأوقفت بيونج يانج اختبارات صواريخها بعيدة المدى وتجاربها النووية، وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حد ما، ومع انعقاد مؤتمرين قمة بين ترامب وكيم. الأول– في سنغافورة في يونيو 2018 – وصدر عنه بيان واهٍ حول المبادئ المتفق عليها وإمكانية إجراء مفاوضات دبلوماسية. بينما فشل الثاني – الذي عقد في هانوي في فبراير 2019– عندما أصبحت الهوة بين الزعيمين حول نطاق وتسلسل نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات واضحة.
منذ ذلك الحين، توتر الجو الدبلوماسي. في أبريل 2019، حدد كيم من جانب واحد موعدًا نهائيًّا في نهاية العام لحكومة الولايات المتحدة لتقديم اتفاق قد يكسر الجمود. وفي يونيو، وافق ترامب وكيم على مصافحة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، لبدء محادثات على مستوى العمل. ومع ذلك، في أكتوبر، لم يفلح عقد اجتماع استغرق ثماني ساعات بين مبعوثي السويد.
وطرح الزعيمان في بعض الأحيان فكرة عقد قمة ثالثة، لكنهما تراجعا على الأقل في الوقت الحالي، وقد يكون هذا للأفضل: قد يؤدي اجتماع آخر غير مهيأ إلى شعور الطرفين بالإحباط الشديد.
وعلى الرغم من أن تحذير بيونج يانج من تقديمها “هدية عيد الميلاد” لواشنطن إذا لم تقدم الولايات المتحدة ما اعتبره كيم طريقة مرضية للمضي قدمًا لم يكن قد تحقق في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أن آفاق الدبلوماسية بدأت تخبو وتضعف.
ومع ذلك، يجب على الطرفين التفكير فيما سيحدث إذا فشلت الدبلوماسية. ففي حالة ما إذا صعدت كوريا الشمالية من استفزازاتها، يمكن أن تتصرف إدارة ترامب كما فعلت في عام 2017، من خلال التنابز والسباب والجهود الرامية إلى تشديد العقوبات واستكشاف الخيارات العسكرية مع عواقب لا يمكن تصورها.
هذه الديناميكية ستكون وبالاً على المنطقة والعالم فضلًا عن كلا الزعيمين. ولا يزال الخيار الأفضل لهما هو صفقة بناء الثقة وإجراءات متبادلة تعطي كلاهما مزايا متواضعة. وتحتاج بيونج يانج وواشنطن إلى تحديد الوقت المناسب للتفاوض وقياس إمكانيات التسوية. وفي عام 2020، يجب على ترامب وكيم الابتعاد عن المسابقات عالية المستوى والاستفزازات الدرامية، وتمكين مفاوضيهما من العمل.
8- كشمير
بعد أن باتت كشمير خارج نطاق الاهتمام الدولي لسنوات، أدى تصاعد بين الهند وباكستان في عام 2019 على منطقة كشمير المتنازع عليها إلى إعادة تركيز الأزمة بشكل حاد. فكلا البلدين يطالب بإقليم الهيمالايا الذي تقسمه حدود غير رسمية، والمعروفة باسم خط السيطرة، والتي رسمت منذ الحرب الهندية الباكستانية الأولى في 1947-1948.
أولاً، الهجوم الانتحاري الذي شنّه متشددون إسلاميون في فبراير ضد القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير. وردت الهند بقصف معسكر متشدد مزعوم في باكستان؛ ما دفع بضربة باكستانية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. وتصاعدت التوترات مرة أخرى في أغسطس عندما ألغت الهند وضع جامو وكشمير التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، والتي كانت بمثابة الأساس لانضمامها إلى الهند قبل 72 عامًا، وجعلتها تحت حكم نيودلهي المباشر.
قامت حكومة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” بإجراء هذا التغيير في الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة دون أي استشارة محلية. وليس ذلك فحسب، فقبل إعلان قرارها، جمعت عشرات الآلاف من القوات الإضافية وقطعت جميع الاتصالات، واعتقلت آلاف الكشميريين، بما في ذلك الطبقة السياسية برمتها، رغم أن الكثير منهم لم يكونوا مُعادين للهند.
وقد فاقمت هذه التحركات شعورًا عميقًا بالعزلة بين الكشميريين، والذي ربما سيؤدي إلى مزيد من التمرد الانفصالي الطويل الأمد. وبشكل منفصل، أثار قانون الجنسية الجديد للحكومة الهندية، والذي يُنظر إليه على أنه معادٍ للمسلمين، احتجاجات وردود فعل عنيفة من جانب الشرطة في أجزاء كثيرة من الهند. وإلى جانب الإجراءات في كشمير، يبدو أن هذه التطورات تؤكد عزم “مودي” على تنفيذ أجندة قومية هندوسية.
إن أكبر خطر هو خطورة أن يؤدي هجوم متشدد إلى تصعيد. ففي كشمير، المتمردون كامنون ولكنهم لا يزالون نشطين، كما أن العمليات الهندية العسكرية المكثفة في كشمير خلال السنوات القليلة الماضية ألهمت جيلًا جديدًا من أبناء الوطن، ومن المرجح أن تتزايد صفوفهم بعد عملية القمع الأخيرة. ومن المؤكد أن توجيه ضربة للقوات الهندية من شأنه أن يعجل بالانتقام الهندي من باكستان، بغض النظر عما إذا كانت إسلام آباد متواطئة في تلك الخطة أم لا. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تجر الجارتان المسلحتان نوويًّا إلى خوض الحرب.
يجب على الجهات الخارجية أن تدفع باتجاه التقارب قبل فوات الأوان. وهذا لن يكون سهلًا؛ فالطرفان يؤديان دورهما في الدوائر الانتخابية المحلية دون أي تنازلات. ويعدّ استئناف الحوار الثنائي، الذي ظل معلقًا منذ عام 2016، أمرًا ضروريًّا وسيحتاج إلى ضغط منسق، لا سيما من الحكومات الغربية. وأي تقدم يتطلب من باكستان اتخاذ إجراء موثوق به ضد الجهاديين الذين ينطلقون من أراضيها، وهو شرط مسبق لا يمكن التفاوض بشأنه حتى تقبل الهند الجلوس على طاولة المفاوضات. من جانبها، يتعين على الهند رفع الحظر الكامل على الاتصالات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإعادة الاندماج بشكل عاجل مع قادة كشمير، كما يتعين على الجانبين استئناف التجارة عبر الحدود وإتاحة السفر إلى كشمير.
وإذا ظهرت أزمة جديدة، فسيتعين على القوى الأجنبية أن تلقي بثقلها للحفاظ على استقرار السلام على الحدود المتنازع عليها.
9- فنزويلا
لا يزال الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” مسئولًا، ورغم أنه تخلص من الانتفاضة المدنية والعسكرية في أبريل وتغلب على المقاطعة الإقليمية وحزمة من العقوبات الأمريكية؛ غير أن حكومته لا تزال معزولة ومحرومة من الموارد، فيما يعاني معظم الفنزويليين من فقرٍ طاحن وانهيار الخدمات العامة.
اجتذب “خوان غوايدو”، الذي تولَّى بصفته رئيسًا للجمعية الوطنية الرئاسة المؤقتة في يناير الماضي، حشودًا ضخمة ودعمًا أجنبيًّا لمطالبته بأن يترك مادورو، الذي أعيد انتخابه في استطلاع مثير للجدل في عام 2018، منصبه. ومع ذلك، فإن بقاء الحكومة التي لا تحظى بشعبية قد قدم إلى غوايدو، وكذلك الولايات المتحدة وحلفائها في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا، دروسًا قاسية. لا أحد يستطيع أن يستبعد انهيار الحكومة، ومع هذا، فإن الأمل في ذلك – كما قال أحد نواب المعارضة لزملائي في مجموعة الأزمات الدولية – “مثل كونك فقيرًا وتنتظر الفوز باليانصيب”.
وفي البداية، قلّل منافسو مادورو من قوة حكومته، وقبل كل شيء، ولاء القوات المسلحة له.
وعلى الرغم من الأزمات، ظلت المجتمعات الفقيرة غير مقتنعة بالمعارضة. ورغم أن العقوبات الأمريكية فرضت ضغوطًا على السكان وألحقت أضرارًا بصناعة النفط المتعثرة، بيد أن الجهات الفاعلة الغامضة تحايلت عليها من خلال العمل عبر ثغرات الاقتصاد العالمي، حيث أبقت صادرات الذهب والدولار النقدي البلاد ثابتة على مستوى النخبة الصغيرة. وانضم الكثير ممن اضطُروا إلى الهجرة الجماعية من الفنزويليين، الذين يبلغ عددهم الآن 4.5 مليون، والذين قاموا بدورهم بنقل التحويلات المالية إلى ديارهم لإعالة أسرهم.
وكان للأزمة آثار مضاعفة أخرى؛ فالأمم المتحدة تقدر حاجة نحو سبعة ملايين فنزويلي إلى مساعدات إنسانية، وكثير منهم يقيم في المناطق الحدودية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بما فيها المقاتلون الكولومبيون. وعلى الرغم من تقاسم أكثر من 1300 ميل من الحدود المتسمة بالنشاطات الإجرامية والعنيفة وغير الخاضعة للحراسة، لم تعد الحكومتان الكولومبية والفنزويلية تتحدثان مع بعضهما البعض. وبدلاً من ذلك، تتبادلان الاتهامات واللوم على إيواء الوكلاء المسلحين، وأصبحت الحدود نقطة انطلاق في فنزويلا. وفي غضون ذلك، أدى الانقسام بين دول أمريكا اللاتينية التي تدعم غوايدو وتلك التي تدعم مادورو إلى تفاقم المناخ الإقليمي شديد الاستقطاب.
ولا يزال هناك طريق تفاوضي للخروج من هذا الاضطراب؛ وهو ما سيترتب عليه حل وسط من جميع الأطراف: على المعارضة أن تتخلى عن مطالبها بخروج مادورو من السلطة الآن؛ كما سيتعين على الحكومة أن تقبل الخطوات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ذات مصداقية ومراقبة دولية في عام 2020، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذات مصداقية بنفس القدر في المستقبل القريب؛ وستحتاج الحكومة الأمريكية إلى تخفيف العقوبات تدريجيًّا مع إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل. سيكون هذا ثمنًا مقبولًا للسلام والاستقرار في فنزويلا، من أجل تجنب كارثة أسوأ بكثير.
10- أوكرانيا
فتح فولوديمير زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي تحول إلى رئيس، والذي تم انتخابه في أبريل 2019، نافذة جديدة دافعة للجهود المبذولة لإنهاء صراع كييف المستمر منذ ست سنوات مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في منطقة دونباس شرقي البلاد. ومع ذلك، فإذا كانت عملية السلام تبدو معقولة أكثر مما كان عليه قبل عام، فهي بعيدة عن أن تتحقق.
وقد تعهد زيلينسكي أثناء حملته بتحقيق السلام. وقد فسر فوزه الساحق وحزبه في انتخابات 2019 على أنه تفويض للقيام بذلك. وقد بدأ بالفعل في التفاوض على عمليات الانسحاب المتبادلة من مواقع المواجهة ووقف إطلاق النار مع روسيا وعملائها. وفي سبتمبر، أبرم صفقة مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” حول تبادل الأسرى. وفي الشهر التالي، أيد ما يسمى بـ “صيغة شتاينماير” التي قدمها فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني آنذاك والذي أصبح رئيسها منذ عام 2016، والذي اقترح أن تؤدى الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون أولًا إلى وضع خاص مؤقت، ثم سيكون دائمًا إذا ما كان التصويت ذا مصداقية ومن ثم إعادة الاندماج في أوكرانيا.
واتخذ زيلينسكي الصيغة المطلوبة للسيطرة الأوكرانية في تلك المناطق قبل التصويت. ومع ذلك فقد واجه رد فعل محلي فوري من تحالف محتمل من منظمات المحاربين القدامى العسكريين، والجماعات اليمينية المتطرفة، والمثقفين. وفي المقابل، رحبت موسكو والقادة الانفصاليين بقبول زيلينسكي للصيغة، رغم شروطه.
في ديسمبر، التقى زيلينسكي وبوتين في باريس مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفشل الزعماء في الاتفاق على خطة مينسك، لكنهم اتفقوا على خططٍ لوقف إطلاق النار أكثر شمولًا، ومزيد من فك الارتباط في مواقع الجبهة، وزيادة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإنشاء نقاط عبور جديدة للمدنيين على خط الاتصال تفصل بين القوات الأوكرانية والانفصاليين. ويبدو أن منتقدي زيلينسكي في أوكرانيا راضون عن موقفه الرافض في باريس؛ وهو ما يعطيه مساحة أكبر للمناورة.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن الاجتماع المقبل في فرنسا، والمقرر عقده في فصل الربيع، ينبغي أن يتناول المكونات الأخرى لاتفاق مينسك، بما في ذلك العفو، ومزيد من عمليات سحب القوات، والطريق إلى إعادة دمج المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا.
ويمكن أن يحدث خطأ كبير، وقد تنهار خطط وقف إطلاق النار وفض الاشتباك؛ وربما يتصاعد القتال، ومع ذلك يحتاج زيلينسكي إلى موسكو لتقديم تنازلات من أجل السلام ليستفيد من الفرصة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن موسكو كانت أكثر استعدادًا للتعامل مع زيلينسكي من سلفه، إلا أن مواقفها الأساسية لم تتغير، فهي تنفي أن تكون طرفًا في النزاع الذي بادرت به، وقاتلت فيه وموَّلته. وتصر بأن على كييف التفاوض بشأن الحكم الذاتي لمنطقة دونباس مع القادة الانفصاليين.
ومن شأن عملية السلام أن تقدّم أرباحًا واضحة لأوكرانيا، وأن تحمل فوائد بالنسبة لروسيا، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات وإزالة عبء الدعم المالي والعسكري للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون؛ فيما يحتاج زيلينسكي من حلفائه الغربيين إلى كل مساعدة يمكنه الحصول عليها بينما يواصل هجومه الساحر في شرق أوكرانيا ويتواصل مع موسكو.
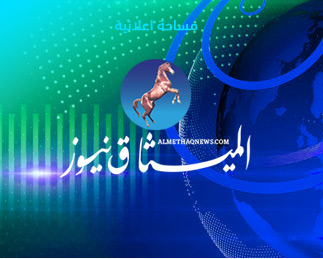
- المقالات
- حوارات